عنوان الموضوع : منتديات العندليب سنة ثالثة متوسط
مقدم من طرف منتديات العندليب
الدولة العبـــــــاسية
يتفق بعض المؤرخين على تقسيم الدولة العباسية الى عصرين متميزين : عصر عباسي أول يعبرون عنه بالعصر الزاهي ، ويمتد من نشأة الدولة عام 132هـ حتى أيام الخليفة الواثق بن المعتصم سنة 232هـ وبموته انتهى العصر الذهبي للدولة العباسية ، وعصر ثان هو عصر التدهور والإنحلال ، ابتدأ بخلافة المتوكل على الله سنة 232هـ وانتهى بسقوط الدولة العباسية على أيدي التتار سنة 656هـ .
ويعمد فريق من المؤرخين الى جعل العصور العباسية أربعة تبعا للنفوذ السياسي الذي شهدته بغداد وللأوضاع السياسية التي كانت سائدة :
العصر العباسي الأول : دام نحوا من قرن ، امتاز بالنفوذ الفارسي ، حكمه سبعة خلفاء، وهو عصر القوة والزهو.
العصر العباسي الثاني : دام نحوا من قرن ، امتاز بالنفوذ التركي مع الخليفة المعتصم ، وفيه كان بدء الضعف.
العصر العباسي الثالث : دام نحوا من قرن ، امتاز بالنفوذ البديهي وهو عصر الضعف الفعلي وقيام الدويلات ومنها : الحمدانية في الموصل وحلب ، البويهية في شيراز ، الأخشيدية في الفسطاط بمصر …الخ.
العصر العباسي الرابع : دام نحوا من قرنين ، وهو عصر الانحلال الذي انتهى بسقوط بغداد في أيدي المغول سنة 656هـ (1258م ) ، كما امتاز بالنفوذ السلجوقي .
وقد أخذ العباسيون باستخدامهم الأعاجم ، بدلا من العصبية العربية التي اعتمدتها الدولة الأموية اعتمادا كليا .. واحتاج العباسيون في اصطناعهم الأعاجم الى المال ، فوقعوا تحت نفوذ الأغنياء كما أصبح الأعاجم من الفرس والترك والديلم والصغد وغيرهم ، يتسابقون الى الإستئثار بالنفوذ عن طريق المال .
وحكمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ساست فيها العالم .. وفي ذلك يقول الفخري صاحب الآداب السلطانية : " واعلم أن هذه الدولة من كبريات الدول ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان أخيار الناس وصلحاؤها يطيعونها تدينا ، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة .. لقد كانت دولة كثيرة المحاسن ، جمة المكارم أسواق العالم فيها قائمة وبضائع الآداب فيها نافقة ، وشعائر الدين فيها معظمة ، والخيرات فيها دارة ، والدنيا عامرة ، والحرمات مرعية ، والثغور محصنة .. ومازالت على ذلك حتى أواخرها ، فانتشر الجبر واضطرب الأمر ، وانتقلت الدولة ".
أبو العباس السفاح .. مؤسس الدولة العباسية
هو أول من جلس على عرش الدولة العباسية سنة 231 هـ، وفي يوم الجمعة أقام أبو العباس الخطبة على المنبر قائماً، وكان بنو أمية يخطبون قعوداً ، فحياه الناس وقالوا: " أحييت السنة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم". وختم خطبته بقوله: "أنا السفاح المبح، والثائر المبيد"، فعرف من ثم بالسفاح .. وقد قضى السفاح معظم عهده في محاربة قواد العرب الذين ناصروا الدولة الأموية، وقضى على أعقاب الأمويين، حتى أنه لم يفلت منهم إلا عبدالرحمن الداخل مع نفر من أهله .. كذلك وجه السفاح همته إلى الفتك بمن والوا عبد الرحمن الداخل وساعدوه على تأسيس دولته في الأندلس، فقتل أبا سلمة الخلال، وهم بقتل أبي مسلم لولا أن المنية عاجلته .. وكان أبو العباس جميلاً وسيماً كريماً وقوراً سخياً، كثير الجباء .. وقد بقي في الخلافة أربع سنوات وتسعة أشهر ومات بالجدري في مدينة الأنبار التي اتخذها قاعدة لخلافته سنة 631 هـ، وكان ابن ثلاث وثلاثين سنة.
بعد السفاح تولى أبو جعفر المنصور الخلافة
ويعد المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية لأنه أحكم الرابطة بين القوة الزمنية والسلطة الدينية
ومن أهم أعماله بناء بغداد وتحصين الحدود بينه وبين الروم
ولما أنهكت الأعمال صحته، قصد مكة ليقضي فيها بقية حياته، فمات على بعض ساعات منها، وذلك سنة 851 هـ.
تولى المهدي ابنه الخلافة وقد رسخت قدم الدولة وثبتت دعائمها،
فعفا عن المسجونين السياسيين، ورد إلى بني هاشم ما كان والده قد أخذه منهم، ووسع المدارس وزاد من عددها، كما وسع الحرم النبوي في المدينة المنورة، وأنشأ القصور على الطريق من بغداد إلى مكة، وسعى في توفير الماء على طول هذه الطريق، كذلك رتب البريد بين مكة والمدينة
وجاء بعد المهدي ابنه موسى الهادي سنة 169 هـ، فلم يعمر أكثر من أربعة عشر شهراً وقد حاول أن يخلع أخاه الرشيد من ولاية العهد وينقلها إلى ابنه جعفر وبينما هو يسعى لاتمام ذلك عاجلته منيته سنة 170 هـ
هارون الرشيد :
مع تولي الرشيد الخلافة 170 هـ بلغت الدولة العباسية
وقد شيد الرشيد من المساجد والمدارس والمستشفيات والقناطر والترع، ما يشهد له بالحرص على مصالح رعيته، والهمل على راحتهم .. وفي عصره عظمت بغداد وكثرت فيها القصور الفخمة التي أبدع المهندسون تنسيقها .. وعظمت كذلك الرصافة المقابلة لها على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، وذلك بفضل ما أنشأه البرامكة من قصور ومساجد وحمامات .. وفي عهده اتسع عمران العاصمة حتى بلغ مليوني نسمة، وصارت ملتقى التجارة بين الهند والصين والشام والجزيرة وبحر المشرق .. وقد زاد تبعاً لذلك خراج الدولة، فأخذ الخليفة ووزراؤه يغدقون بدون حساب على الشعراء والعلماء والكتاب والمحتاجين، وينفق هؤلاء عن سعة .. فراجت التجارة، وكثر التأنق في المعيشة، وبلغ الترف مبلغه الذي سارت به الأمثال في أنحاء المعمورة، ولم ينقطع تغني الشعراء به حتى وقتنا هذا .. وعهد هارون لأبنائه الأمين، ثم المأمون، ثم القاسم، وأخذ عليهم العهود بألا يغيروا هذا الترتيب .. ومات الرشيد بعد أن حكم ثلاثاً وعشرين سنة،
ثم تولى الأمين الخلافة بعد أبيه سنة 193 هـ، فكان مسرفاً، مغرماً بالبذخ والترف
وحاصر المأمون بغداد إلى أن سلم الأمين نفسه لأخيه .. ولكن بعض الجند الفرس قتلوه، وقد أكرم المأمون أبناء أخيه وزوجهم من بناته .. وكان المأمون مولعاً بالعلوم والفلسفة والآداب، فكان عصره أرقى العهود في العصر العباسي .. وظهر فيه علماء مشهورون من أهل الحديث وعلماء الكلام، وجعل لهم المأمون مجالس للمناظرة .. وكانت الترجمة عن الفرس واليونان والهنود قد بدأت من قبل، وبخاصة الطب، فنقلت عن اليونانية أيام المنصور كتب أبقراط وجالينوس في الطب، وترجم ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة عن البهلوية، كما ترجم المجسطي لبطليموس.
توفي المأمون في آخر غزواته ببلاد الدولة البيزنطية سنة 218 هـ، إذ أصابته الحمى فقضت عليه،
وكان قد أوصى بالخلافة بعده إلى أخيه المعتصم .. وقد أوصى المأمون أخاه المعتصم وصية جاء فيها: "يا أبا إسحاق، أدن مني، واتعظ بما ترى، وخذ بسيرة أخيك في القرآن، واعمل على الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله، الخائف من عذابه وعقابه، ولا تغتر بالله ومهلته، فكأن، قد نزل بك الموت، ولا تغفل أمر الرعية، والعوام العوام، فإن الملك، الملك بهم، والمنفعة فيهم وفي غيرهم من المسلمين".
اسباب سقوط الدولة العباسية
1- تفوق العناصر غير العربية: كان الأمويون يعتمدون على العرب، ويولونهم المناصب العالية كلها، مما أثار حفيظة [غيظ] الموالي من الفرس فعملوا على القضاء على دولتهم، لعلهم يستردون شيئاً من سابق نفوذهم وسلطانهم القديم فأخذوا ينشرون الدعوة لبني العباس، وتمكنوا في النهاية من انتزاع الخلافة من الأمويين، فجاءت دولة العباسيين فارسية الصبغة وقد عمل الفرس على اقصاء العصبية العربية عن الخلفاء بحجة أن العرب يطمحون إلى الخلافة، فأصبح الفرس يحكمون الدولة، كما نرى ذلك مممثلاً في سطوة البرامكة ولما خشي المعتصم مغبة الأمر استكثر من المماليك الأتراك واتخذ منهم جنداً استعان بهم على الفرس والعرب معاً.
2- سوء الحالة الإقتصادية : بعد أن وطد خلفاء العصر العباسي الأول أركان الملك، جاء من بعدهم حكام اخلدوا إلى الدعة [الراحة والهدوء]، وامعنوا في الترف وجر ذلك إلى كثرة في النفقات وزيادة الضرائب، فانحطت موارد الثروة وقل ايراد الحكومة، وضعفت بالتالي شوكة الدولة وعجزت عن تحصيل ضرائبها.
3- ظهور الدويلات المستقلة: تمكن العلويون من اقتطاع أجزاء من الدولة العباسية أصبحت مستقلة عنها ومنها دولة الأدارسة في المغرب، والدولة الفاطمية التي امتدت من المحيط الأطلسي إلى اليمن والحجاز، ودولة بني بويه التي سيطرت على بغداد، وغير ذلك من الدول في العالم الإسلامي ويضاف إلى ذلك أن اتساع الرقعة العباسية حمل الخلفاء على تعيين حكام من أعوانهم على المناطق النائية، فعمد أولئك الحكام إلى الاستقلال بمقاطعاتهم عن بغداد.
4- تعدد الأجناس والمذاهب: لم يكن تعدد الأجناس وظهور مذاهب دينية معروفاً أيام الأمويين، بل سرت إلى الإسلام في العصر العباسي من الديانات القديمة كالمجوسية والمانوية والمزدكية وقد أدى ذلك إلى كثرة الملل والنحل، كما أذكى نار العداوة بين المسلمين فتفرقوا مللاً وأحزاباً، تحسبهم جميعاً وقلوبهم مشتتة.
حروب الدولة العباسية :
في بلاد الهند : لما قامت الدولة العباسية ولى أبو جعفر المنصور هشام بن عمر التغلبي بلاد السند .. وفي عهده فتحت كشمير وهدم معبد "بوذا" وبني في موضعه مسجد .. وقد تقدمت هذه البلاد في عهد هشام التغلبي واستقر بها الأمن وتوطدت أركانه .. وفي عهد الخليفة المهدي غزا المسلمون بلاد الهند 901 هـ وحاصروا مدينة "باربد" وضربوها بالمنجنيق وفتحوها عنوة على أن هذه الغزوة كانت كارثة على جند العباسيين، فقد فشا الموت فيهم وقضى على عدد كبير من المقاتلين، ثم دمرت الزوابع سفنهم في الخليج العربي فغرق كثير من الجند .. وفي عهد الخليفة المأمون توسعت فتوحات المسلمين في السند والهند، وفي عهد المعتصم انتشر الإسلام في البلاد الواقعة بين كشمير وكابول والملتان.
مع البيزنطيين :
لم تنقطع الحرب بين العرب والروم منذ ظهور الإسلام. فلما انتقل الحكم إلى العباسيين تغيرت وجهة الحرب بينهما وأصبحت عبارة عن غارات، الغرض منها الهدم والتخريب وإتلاف النفس والمال وهذا ما كان يخالف ما كانت عليه الحال أيام الأمويين الذين كانت لهم سياسة مرسومة لمحاربة البيزنطيين بغية احتلال القسطنطينية وبقيت الحرب بين العباسيين والبيزنطيين تشتعل من حين إلى آخر حتى سنة 551هـ، حين طلب الإمبراطور قسطنطين الرابع الصلح مع العباسيين على أن يؤدي لهم جزية سنوية.
وفي سنة 951 هـ خرج الخليفة المهدي على رأس جيش كثيف لغزو بلاد الروم، ووصل إلى "البردان" وعسكر به، وأرسل العباس بن محمد فبلغ أنقرة، وفي سنة 561 هـ أعاد المهدي الكرة على البلاد البيزنطية فجمع جيشاً كثيفاً وعبر الفرات وجعل عليه ابنه هارون فوصل هذا الجيش إلى سواحل البوسفور وأرغم الملكة "ايرين" أرملة "ليو" الرابع، وكانت وصية على ابنها قسطنطين السادس أن تدفع للمسلمين تسعين ألف دينار جزية سنوية، وأن تقيم لهم الأسواق والأدلاء في الطريق عند عودتهم إلى بلادهم، وأن تسلم أسرى المسلمين وانتهت هذه الغزوة بهدنة بين الفريقين لمدة ثلاث سنوات ولما تولى الرشيد الخلافة سار بنفسه سنة 181 هـ على رأس جيش كبير إلى آسيا الصغرى، فانتصر على البيزنطيين في معارك كثيرة وظل يتابع فتوحه حتى وصل إلى القسطنطينية فسارعت الامبراطورة "ايرين" إلى طلب الهدنة مقابل دفع الجزية السابق ذكرها غير أن نقفور الذي اعتلى العرش بن ايرين أرسل إلى الرشيد سنة 781 هـ كتاباً ينتقض فيه الهدنة، ويلح في استرداد الجزية من جديد. ولم يقتصر الرشيد في حروبه مع الروم على آسيا الصغرى، بل تعداها إلى البحر المتوسط ففي سنة 190 هـ غزا جزيرة قبرص وأسر منها عدداً كبيراً من بينهم أسقفها.
أما عصر المأمون فقد اكتفى بتشجيع توماس الصقلبي الثائر على الامبراطور "تيوفيليوس"، وعمل على تتويجه امبراطوراً على الدولة البيزنطية نفسها ولكن سرعان ما اكتشفت حملة توماس ولم يتم له ما أراد وقد اتبع الامبراطور البيزنطي السياسة نفسها مع الخليفة العباسي، فجل بلاد الروم موئلاً للخرمية أتباع بابك الخرمي الفارسي الذي ثار سنة 102 هـ على المأمون وقد استطاع المعتصم القضاء على بابك، ثم تفرغ لمحاربة الروم، فسار من فوره إلى أنقرة في جيش ضخم، وهزم الامبراطور البيزنطي واستولى على أنقرة. ثم تابع المسير حتى وصل عمورية حيث انتصر على البيزنطيين سنة 322 هـ، واقتحم عمورية وخربها وعاد إلى سامراء حيث استقبل استقبالاً باهراً وفي هذه المناسبة نظم أبو تمام قصيدة مشهورة جاء فيها:
السيف أصدق أنباء من الكتب ... في حده الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصحائف ... في متونهم جلاء الشك والريب
فيما بعد ساءت الحال في الدولة العباسية، فاستبد الأتراك والبويهيون بالسلطة دون الخلفاء فوجد البيزنطيون في ذلك فرصة سانحة للإغارة على المناطق الخاضعة للدولة العباسية فقد استولوا على ساحل مصر سنة 832 هـ، كما أغاروا في زمن المتوكل على مدينة "عين زربا" سنة 142 هـ، وعلى الأراضي الواقعة شمالي العراق فبلغوا آمد وأسروا كثيراً من المسلمين ولكن الخليفة المتوكل عول على الانتقام، فاستولى على بعض المناطق البيزنطية جنوبي آسيا الصغرى وأسر أحد البطارقة، واستولى على مدينة لؤولؤة ومنذ عهد الخليفة المعتمد كانت الخلافة العباسية قد تقلصت إلى حدود الجزيرة والعراق، وتجدد النزاع بين المسلمين والروم الذين راحوا يعبثون ببعض بلاد الدولة العباسية .. وكانت شوكة الدولة البيزنطية قد قويت وانتشر فيها الأمن منذ اعتلاء باسيل الأول العرش سنة (352 هـ) 768م، فتمكن من احراز النصر على بعض أمراء المسلمين، ساعده على ذلك ضعف الخلفاء أو استبداد القوط بهم وثورة الجند عليهم.
الحروب في مصر :
كان من أثر تحول الخلافة من الأمويين إلى العباسيين أن قامت حضارة جديدة حلت مكان الفسطاط، هي العسكر وقد قام الجند العرب في مصر بدور مهم في شؤون الدولة السياسي. فقد اشتركوا في كثير من الفتن والثورات، مثل فتنة محمد النفس الزكية في عهد المنصور وعاونوا "دحية" في خروجه على العباسيين في الصعيد، في عهد الخليفة المهدي كذلك كان للجند العرب في مصر نصيب كبير في الفتنة التي قامت بين الأمين والمأمون وغدا اشتراك هؤلاء الجند في الثورات مألوفاً حتى في الحالات التي لم يكن ثمة ما يدعو إلى الاشتراك فيها وقد دعت هذه الحال الخليفة المعتصم سنة 812 هـ إلى أن يسقط أسماء الجند العرب في مصر من ديوان العطاء وبذلك اندمج العرب بالمصريين فاحترفوا الزراعة والصناعة وغيرها، وبذلك قضي تماماً على العصبيات العربية والشعوبيات في مصر وهذا أمر لم يحدث في أي اقليم آخر من الأقاليم التابعة للدولة الإسلامية.
في بلاد النوبة :
اتصل العرب اتصالاً وثيقاً بالبجة في القرن الثاني للهجرة عن طريق البحر الأحمر، وعن طريق وادي النيل، وخاصة اقليم أسوان، بعد أن عقد مع ابن الحبحاب معاهدة هدنة وحسن جوار غير أن البجة لم يحافظوا على العهد الذي قطعوه على أنفسهم مه ابن الحبحاب، وكثرت غاراتهم على جهات أسوان عهد الخليفة المأمون فقامت بين الفريقين مواقع عدة انتهت بإبرام هدنة جديدة، كان من أهم شروطها أن تكون بلاد البجة من حدود أسوان، وعلى أن تكون منطقة السودان ملكاً للخليفة العباسي، وأن يدفع ملك البجة كل عام الخرج، وهو مائة من الإبل أو ثلاثمائة دينار وأن يحترم البجة الإسلام ولا يمنعوا أحداً كل عام من المسلمين الدخول في بلادهم للتجارة، وإذا نزل البجة صعيد مصر مجتازين أو تجاراً فلا يظهرون سلاحاً ولا يدخلون المدن والقرى بحال.
في بلاد المغرب :
غدت أفريقيا مسرحاً للفتن والقلاقل في العصر العباسي، وذلك لبعدها عن السلطة المركزية في بغداد، ولجهل البربر في ذلك العصر، وعدم استعدادهم لقبول الحضارة الإسلامية وبغضهم ولاتهم من العرب وفرضهم الضرائب الفادحة عليهم وقد ساعد هذا الواقع على قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة 271 هـ، كما ساعد الأغالبة في تونس على تأسيس دولتهم، وكان الرشيد قد أقطع ابراهيم بن الأغلب تونس سنة 481 هـ.
أما عن جهل البربر وعدم استعدادهم للحضارة الإسلامية، فكان من آثاره أن السلام لم يتوطد بين البربر والعرب النازلين في بلادهم منذ أن امتدت الفتوحات الإسلامية إلى هذه البلاد وهذا يفسر لنا انتشار مذهبي الخوارج والشيعة في بلاد المغرب، وقيام البربر في وجه العباسيين بين الحين والآخر. وأما عن بغض البربر لولاتهم من العرب فيرجع إلى فداحة الضرائب التي أثقلت كاهل الأهلين .. والحق أن قيام الخوارج من البربر في وجه العباسيين لم يكن خروجاً على الدين بل كان خروجاً على السلطة الحاكمة لظلم الولاة لهم وفرضهم عليهم الضرائب الفادحة.
استمرت قبائل البربر في أفريقيا تناوئ سلطان العباسيين، حتى بعث إليهم الرشيد سنة 181 هـ هرثمة بن أعين على رأس جيش كثيف استطاع أن يضعف قوتهم على أن هرثمة رأى بثاقب نظره وطول خبرته تأصل العداء في نفوس البربر، فأرسل إلى الرشيد يعتذر عن البقاء بالمغرب بعد أن وليها سنتين ونصف السنة .. ثم ولى الرشيد محمد بن مقاتل، فأساء معاملة الأهلين، فتجددت ثورات البربر والعرب، وتمكن البربر من دخول القيروان .. إلا أن ابراهيم بن الأغلب تمكن من طردهم، وأعاد إلى الرشيد ولايته .. وكان من أثر العداء الذي اضمره البربر للأمويين والعباسيين، وانضمام بعض العرب إلى مذهب الخارجين أن قامت الفتن والقلاقل في هذه البلاد، وعمل بعض زعمائهم على الاستقلال عن الدولة العباسية، فتأسست ولايات من البربر، على يد زعماء من العرب، استقلت استقلالاً يكاد يكون تاماً ومن الولايات التي استقلت ولاية تاهوت وولاية سلجمانة (تافيلالت الحالية) التي أسسها بنو مدرار، وولاية تلمسان التي أسسها الصنهاجيون، وولاية برغواطة في تامسنا (الشاوية الحالية) على ساحل المحيط الأطلسي، ودولة الأغالبة في تونس، ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى.
في بلاد الأندلس :
تقلص سلطان العباسيين عن بلاد الأندلس بعد أن أفلت عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وانتقل إلى الأندلس ولكن أبا جعفر المنصور لم يهدأ باله من ناحية عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) ، فعمل على القضاء عليه، وأرسل إليه العلاء بن مغيث ولكن الداخل هزمه وقتله واحتز رأسه وأرسله إلى المنصور .. فغير المنصور بعد ذلك سياسته مع الداخل وعمل على استمالته، وكثيراً ما كان يظهر اعجابه بشخصيته، وقد لقبه بصقر قريش .. وكان الخليفة المهدي يضمر العداء للداخل فأرسل من يحرض عبدالرحمن بن حبيب الفهري عليه فراح يحث الناس على الدخول في طاعة العباسيين، واتصل بسليمان بن يقظان من أجل ذلك ولكن سليمان خذله وحاربه وقضى عليه وبذلك لم تنجح سياسة المهدي في إعادة الأندلس إلى الدولة العباسية .. وقد حكم عبد الرحمن الداخل ثلاثاً وثلاثين سنة، وعاصر من الخلفاء العباسيين: المنصور والمهدي والهادي والرشيد
الأدب العباسي :
الأدب في العصر العباسي
وصلت الحياة الفكرية في العصر العباسي إلى ذروة التطور والازدهار، ولاسيما في العلوم والآداب .. وقد عرف العصر حركات ثقافية مهمة وتيارات فكرية بفضل التدخل بين الأمم .. وكان لنقل التراث اليوناني والفارسي والهندي، وتشجيع الخلفاء والأمراء والولاة، وإقبال العرب على الثقافات المتنوعة، أبعد الأثر في جعل الزمن العباسي عصراً ذهبياً في الحياة الفكرية .. ونحاول فيما يأتي التعرف إلى الإنتاج الأدبي، شعره نثره، على اختلاف فنونه، وما لحقه من خصائص وتطورات.
في العصر العباسي كانت العربية قد أصبحت اللغة الرسمية في البلدان الخاضعة لسيطرة المسلمين، وكانت لغة العلم والأدب والفلسفة والدين لدى جميع الشعوب. وقد كتب النتاج بمجمله في اللغة العربية مع أن قسماً كبيراً من أصحابه ليسوا من العرب !!
تركت الثقافات الدخيلة أثراً عميقاً في علوم العرب وفلسفتهم، ولكن آداب الأعاجم لم يكن لها مثل هذا الأثر فالعرب لم ينقلوا إلا جزءاً ضئيلاً من الآداب الأعجمية، لأنهم لم يشعروا بحاجتهم إليها ولم يكن أدباء العرب وشهراؤهم يتقنون لغات غربية، فظل أدبهم في مجمله صافياً بعيداً عن التيارات الأجنبية.
وقد غلب الطابع العربي على الأعاجم الذين نظموا وكتبوا بالعربية، فتأثروا بالاتجاهات الأدبية العربية وانحصر تجديدهم ضمن القوالب التقليدية فالعصر العباسي حمل الأدب كثيراً من التجديد، ولكن ضمن الأطر التقليدية.
في العصر العباسي انتشرت المعارف، وكثر الاقبال على البحث والتدوين، وأنشئت المكتبات وراجت أسواق الكتب وقد وضعت المؤلفات في مختلف فروع المعرفة، في التاريخ والجغرافيا، والفلك والرياضيات، والطب والكيمياء والصيدلة، والصرف والنحو، واللغة والنقد، والشعر، والقصص والدين، والفللسفة والسياسة، والأخلاق والاجتماع وغير ذلك .. ويكفي أن نقرأ كتاب الفهرست لابن النديم لنعرف إلى أي مدى كانت حركة التأليف مزدهرة .. وأقبل الأدباء على الثقافات الجديدة يكتسبون منها معطيات عقلية، وقدرة على التعليل والاستنباط وتوليد المعاني، والمقارنة والاستنتاج .. فالأدب العباسي جاء أغنى مما سبقه، ويدلنا على هذا الغنى ما نراه في شعر أبي نواس وأبي تمام وأبي الطيب والمتنبي وأبي علاء، وما نراه في نثر ابن المفقع والجاحظ وبديع الزمان وسواهم .. ثم ان عمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الانسانية، فجاءالأدب العباسي زاخراً بالمعطيات الانسسانية من حيث تصويره لجوهر الانسان وما يتعقب على النفس من حالات اليأس والأمل، والضعف والقوة، والحزم والفرح وغير ذلك .. كما رسم الأدب العباسي المشاكل العامة في الاجتماع والفكر والسياسة والأخلاق .. وهذا كله ظهر في خمريات أبي نواس وخواطر الرومي، وحكم المتنبي، ووجدانيات أبي فراس، وتأملات المعري، وأمثال ابن المفقع، وانتقادات الجاحظ .. فضلاً عن ذلك عرف العصر مدارس أدبية شعرية ونثرية، منها مدرسة أبي نواس ومدرسة أبي تمام، ومدرسة أبي العتاهية، ومدرسة المعري في ميادين الشعر.
وفي النثر عرفت مدرسة ابن المفقع، ومدرسة الجاحظ، ودرسة القاضي الفاضل، ومدرسة بديع الزمان الهمذاني وكل من هذه المدارس خصائصها واتجاهاتها، وقد كان لها الفضل في إعلاء شأن الحياة الأدبية في العصر العباسي.
ازدهر الشعر السياسي في العصر الأموي لأسباب متعددة أهمها قيام الأحزاب السياسية وتناحرها .. ولكن هذا اللون انحسرت أهميته في العصر العباسي بسبب ضعف الأحزاب والعصبيات القبلية .. وقد ازدهر بالمقابل شعر المدح بفعل ازدهار الحياة الاقتصادية وتطور الحياة الإجتماعية، مع ميل الخلفاء إلى الترف وحب الإطراء .. فأقبل الشعراء يمجدون الخلافة والأمراء وأصحاب النفوذ، مقابل العطايا السنية وهذا ما جعل الشعراء يحملون بالثروات الطائلة، فيقصدون بغداد والعواصم الأخرى للإقامة في جوار القصور .. وقوي الهجاء كذلك بدافع تحاسد الشعراء، وإلحافهم في طلب الجوائز، وضمنوا هجائهم الكلام المقنع أحياناً.
أما الغزل فقد مال به أصحابه بصورة عامة، إلى التهتك والإباحية، والفحش في الألفاظ وكثر في العصر العباسي الخلعاء من الشعراء الماجنين، وأهمهم أبو نواس، وحماد عجرد، ومطيع بن اياس، والضحاك، ووالبة بن الحباب .. إلا أن فئة من المتعففين حافظ أفرادها على العذرية في الشعر، من أمثال البحتري وأبي تمام وابن الرومي وأبي فراس الحمداني والشريف الرضي فهؤلاء جاءت قصائدهم الغزلية صادرة عن وجدان صحيح فيه الصدق والبراءة والمحافظة على الآداب العامة .. ثم ان الفخر الذي بني في الجاهلية على العصبية القليلة ضعف شأنه مع ظهور الإسلام، إلا ما كان منه جماعياً وبالدين الإسلامي وأهله .. أما العصر العباسي فقد تحول فيه الفخر إلى العصبية العنصرية أو القومية، ولكنه لم يكن قوياً في العصر الأول والثاني.
وقد ازدهر الفخر في العصر الثالث مع اضطراب الأحوال السياسية وكثرة المغمرين والاعتداد بالنفس وأبرز شعراء الفخر أبو الطيب المتنبي وأبو فراس و الشريف الرضي .. وهذه الموضوعات الشعرية كانت معروفة في العصور السابقة وحافظ الشعراء العباسيون على قوتها إلا أن البيئة العباسية ساعدت على ازدهار فنون جديده كانت من قبل ضعيفة أو غير معروفة .. وأهم هذه الفنون شعر المجون الذي كان وليد انتشار الزندقة وتفشي الفساد بفعل اختلاط الشعوب ، واتيان الأعاجم بفنون من الخلاعة والفحش وردئ العادات .. أما شعر الخمر فقد ارتقى على أيدي أبي نواس وصحبه ، وأصابه من معطيات العصر ما جعل الشعراء يبدعون فيه .. ومن دوافع ازدهار شعر الخمر الثقافة التي تيسرت للعباسيين فعمقت تجربتهم وكثفت شعرهم .. فأبو نواس تجاوز الأعشى والأخطل والوليد بن يزيد في هذا الفن ، واهتدى الى معان وصور وآفاق وأساليب صار معها حامل لواء التجديد في الشعر العباسي وجعل من الخمريات رمزا لهذا التجديد وأساسا لنشر الآراء وفلسفة الحياة والوجود .. وبعد أبي نواس استمرت الخمريات فنا شعريا راقيا اشتهر فيه ابن المعتز ومعز الدولة البويهي والغرائي وسواهم.
ومن الفنون الشعرية التي حافظت على رواجها وتطورت في العصر العباسي فن الوصف التي شمل الطبيعة المطبوعة والطبيعية المصنوعة .. ولهذا اهتم الشعراء بالرياض والقصور، والبرك، والأنهار، والجبال، والطيور، والمعارك، ومجالس اللهو، وغير ذلك.
في العصر العباسي تطورت المعاني الشعرية عمقاً وكثافة ودقة في التصوير، فجاءت شاملة للحقائق الانسانية وقد انصرف الشعراء عن المعاني القديمة إلى معان جديدة، يساعد على ذلك ما كسبه العقل العباسي من الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، وما وصلوا إليه من أساليب فنية قوامها المحسنات اللفظية والمعنوية ومثال ذلك أن أبا تمام يجمع في قصيدة "فتح عمورية" بين العملية الفكرية والعملية الفنية، فأخرج من القصيدة شعراً جديداً راقياً، فيه من القديم مسحة ومن الجديد أخرج معاني وصوراً طريفة وكثرت في الشعر العباسي الأمثال والحكم (المتنبي والمعري)، وبرز فيه المنطق والأقيسة العقلية، وترتيب الأفكار (أبو تمام، وابن الرومي، المتنبي). كما ظهر الإبداع في التصوير والاعراب في الخيال، ومجاراة الحياة والفنون في الزخرفة والنقش، والاهتمام بالألوان (ابن الرومي، والبحتري).
امتاز الشعر العباسي بدقة العبارة وحسن الجرس والايقاع، وذلك بتأثير الحضارة ورفاه العيش كما امتاز بخروجه على المنهجية القديمة في بناء القصيدة وترتيب أجزائها. وكثيراً ما ثار الشعراء على الأساليب القديمة، وفي ذلك ذلك يقول المتنبي:
إذا كان شعر فالنسيب المقدم ... أكل بليغ قال شعراً متيم
وتمتاز القصيدة العباسية بوحدة البناء، وفيها صناعة وهندسة، مع استخدام الصور البيانية، فضلاً عن التجديد في الألفاظ المستعملة والموحية.
النثر العباسي :
خطا النثر العباسي خطوات كبيرة، فواكب نهضة العصر وأصبح قادراً على استيعاب المظاهر العلمية والفلسفية والفنية كما أن الموضوعات النثرية تنوعت فشملت مختلف مناحي الحياة .. فالكتابة الفنية توزعت على ديوان الرسائل والتوقيعات وغيرها .. وكان المسؤولون يختارون خيرة الكتاب لغة وبلاغة وعلماً لتسلم الدواوين، ولاسيما ديوان الرسائل الذي كان يقتضي أكثر من غيره اتقان البلاغة والتفنن ، و مستوى رفيع من الثقافة فضلاً عن ذلك النثر الفني القصص و المقامات و النقد الأدبي ، و النوادر ، و الأمثال و الحكم ، و التدوين ، و الرحلات ، و التاريخ ، و العلوم.
وظهرت الرسائل الأدبية التي تضمنت الحكم و جوامع الكلم و الأمثال و الفكاهات و كانت موضوعات الرسائل تتراوح بين الأخبار و الأخوانيات ، والاعتذار وغير ذلك وراجت الرسائل الطويلة في العصر العباسي فتناولت السياسة والأخلاق والإجتماع، كرسالة الصاحبة لابن المقفع، ورسالة القيان ورسالة التربيع والدوير للجاحظ، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري.
وعظم شأن القصص في العصر العباسي، فاتسع نطاقه وأصبح مادة أدبية غزيرة، وتنوعت المؤلفات القصصية فأقبل الناس على مطالعتها وتناقلها ومنها ما اهتم بالحقل الديني ككتاب قصص الأنبياء المسنى بالعرائس للثعلبي، وقصص الأنبياء للكسائي، وقصة يوسف الصديق، وقصة أهل الكهف، وقصة الإسراء والمعراج ومنها القصص الاجتماعية والغرامية والبطولية ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وقصص العذريين، وسيرة عنتر، وحمزة البلوان، وسواها ومنها القصص التاريخية التي تناولت سير الخلفاء والملوك والأمراء كما عرف العصر العباسي القصص الدخيلة المنقولة، نذكر منها كليلة ودمنة، وكتاب مزدك، وكتاب السندباد، وبعضاً من ألف ليلة وليلة، وأكثره خيالي خرافي يدور بعضه على ألسنة الحيوان.
وإلى جانب القصة ازدهر أدب الأقصوصة، وكتاب البخلاء للجاحظ خير مثال على هذا النوع من الأدب وقد امتاز الأدب القصصي العبسي بدقة الوصف والتصوير وبراعة الحوار، والقدرة على استنباط الحقائق وتصوير مرافق الحياة، وتسقط العجائب والغرائب، والكشف عن العقليات والعادات والتقاليد.
وفي العصر العباسي ظهر فن المقامة، وضعه بديع الزمان الهمذاني، ولقي كثيراً من الرواج في العصر العباسي وما بعده .. وهو سرد قصصي يتناول الأخلاق والعادات والأدب واللغة، ويمتاز بألأسلوبه المسجع وأغراقه في الصناعة وكثرة الزخارف والمحسنات المتنوعة .. وفضلاً عما ذكرنا اهتم النثر العباسي بتدوين العلوم على أنواعها وهذه العلوم كانت إما عربية إسلامية كعلوم الشريعة والفقه والتفسير والحديث والقراءات والكلام والنحو والصرف والبيان وغير ذلك، وإما أجنبية التأثير كالمنطق والفلسفة والرياضيات والطب والكيمياء والفلك وعلم النبات والحيوان وغير ذلك. بهذا حاولنا أن نلقي نظرة على الأدب العباسي، شعره ونثره، وأن توضح أهم ما تناوله من موضوعات وما امتاز به من خصائص عامة.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
لموضوع: المشرق الإسلامي أواخر العهد العباسي -1-
-الامتداد المكاني والزماني للدولة العباسية: شملت أجزاء كبيرة من العالم القديم واحتوت مجموعة واسعة الأقاليم مختلفة الأجناس والثقافات مما صعب السيطرة على أقاليم الدولة إذ تأرجحت بين القوة والضعف منذ تأسيسها سنة132هـ/750م إلى غاية سقوطها سنة656هـ/1258م.
2 –الدول التي حكمت باسم الخلافة العباسية:
أ// الدولة البويهية: 334هـ/945م الى447هـ/1055م:تنسب إلى أبي شجاع بويه الذين حولوا العاصمة إلى شيراز بإيران.
ب// دولة السلاجقة :447هـ/1055م الى530هـ/1135م: هي من تركستان ينتمون إلى زعيمهم سلجوق وفي عهدهم وقعت معركة ملاذ كرد التي انهزم فيها البيزنطيون.
ج//الدولة الأيوبية من 564هـ/1169مالى 648هـ/1250م:تنسب إلى نجم الدين أيوب والد صلاح الدين الأيوبي وفي عهدهم وقعت معركة حطين وتحرير القدس من الصليبين وتوحيد مصر والشام.
د// دولة المماليك من 642هـ/1250م إلى 932هـ/1517م:هم شراكسة وأتراك وروم وأكراد ومن أشهر قادتهم الظاهر بيبرس وقطز وقلاوون وابنه الناصر وفي عهدهم ألحقوا بالمغول هزيمة نكراء في معركة عين جالوت بفلسطين.
الموضوع: المشرق الإسلامي أواخر العهد العباسي -2-
/الحضارة العباسية: كان لتنوع الأجناس والثقافات للأمم التي اعتنقت الإسلام الدور الكبير في ظهور حضارة جديدة عظيمة في منجزاتها فظهرت علوم جديدة فقه السيرة ... وتطورت علوم أخرى كالفلسفة والطب...
أ –الحركة الثقافية والفكرية والعلمية: شملت:
- تأسيس المدارس النظامية (نظام الملك) في عهد السلاجقة حيث انتشرت في شكل شبكة شملت معظم مدن المشرق الإسلامي أهم علمائها: الغزالي ،عمر الخيام...
-انتشار التعليم وازدهاره في العهد الأيوبي بين صفوف الحكام والرعية أما المماليك فقد تميز عصرهم بظهور علماء عظماء مثل: ابن تيمية، ابن خلدون...
ب- العمارة والفنون: :اهتم كل من السلاجقة والأيوبيين والمماليك بالفن والعمارة فشيدوا الأبنية الشاهقة والمساجد الفسيحة والمنارات العالية واعتمدوا على استعمال الفسيفساء والرخام ... من مآثرهم : مدرسة الفردوس بسوريا...
اشهر أحداث أواخر العهد العباسي:
أ/ معركة ملاذ كرد: 1071م/464هـ:
هزم فيها السلاجقة الجيوش البيزنطية نتج عنها:
-بداية سيطرة الأتراك على الأناضول وشرق أوروبا.
- الانتقام الأوروبي من المسلمين
ب/ الحروب الصليبية: 1096م الى1291م/489هـ إلى 685هـ: هي حروب أثارتها أوروبا بهدف السيطرة على العالم الإسلامي باركتها الكنيسة ورفع فيها الصليب انتهت بانهزامهم على يد القائد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين سنة1187م/583هـ
=========
>>>> الرد الثاني :
حروب ومعارك شهيرة 21
معركة ملاذكرد battle of manzikert
تعد معركة "ملاذكرد" من أيام المسلمين الخالدة، مثلها مثل بدر، واليرموك، والقادسية، وحطين، وعين جالوت، والزلاقة، وغيرها من المعارك الكبرى التي غيّرت وجه التاريخ، وأثّرت في مسيرته، وكان انتصار المسلمين في ملاذكرد نقطة فاصلة؛ حيث قضت على سيطرة دولة الروم على أكثر مناطق آسيا الصغرى وأضعفت قوتها، ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق المسلمين، حتى سقطت في النهاية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.
كما أنها مهدت للحروب الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين وعجز دولة الروم عن الوقوف في وجه الدولة الفتية، وترتب على ذلك أن الغرب الأوروبي لم يعد يعتمد عليها في حراسة الباب الشرقي لأوروبا ضد هجمات المسلمين، وبدأ يفكر هو في الغزو بنفسه، وأثمر ذلك عن الحملة الصليبية الأولى.
معركة ملاذكرد هي معركة وقعت بين السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان و البيزنطيين بقيادة الإمبراطورها رومانوس ديوجينس في 26 أغسطس 1071/ذي القعدة 463 هـ أنتصر فيها السلاجقة واسر اللإمبراطور البيزنطي بيد السلاجقة وكانت هذة هي البداية أنتهاء الدولة البيزنطية و أندحارها بعد ولم يخلص نفسه إلا بفدية كبيرة قدرها مليون ونصف من الدينارات، وعقد الروم صلحًا مع السلاجقة مدته خمسون عامًا، واعترفوا بسيطرة السلاجقة على المناطق التي فتحوها من بلاد الروم.
Click here to enlarge
الأراضي البيزنطية (بنفسجية), الهجمات البيزنطية (حمراء) والهجمات السلجوقية (خضراء).
السلطان محمد الملقب ألب أرسلان أي الأسد الشجاع:
تولى ألب أرسلان زمام السلطة في البلاد بعد وفاة عمه طغرلبك، وكانت قد حدثت بعض المنازعات حول تولي السلطة في البلاد، لكن ألب أرسلان استطاع أن يتغلب عليها. وكان ألب أرسلان -كعمه طغرل بك- قائداً ماهراً مقداماً، وقد اتخذ سياسة خاصة تعتمد على تثبيت أركان حكمه في البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة ، قبل التطلع الى أخضاع أقاليم جديدة، وضمها إلى دولته. كما كان متلهفاً للجهاد في سبيل الله ، ونشر دعوة الإسلام في داخل الدولة المسيحية المجاورة له، كبلاد الأرمن وبلاد الروم، وكانت روح الجهاد الإسلامي هي المحركة لحركات الفتوحات التي قام بها ألب أرسلان وأكسبتها صبغة دينية، وأصبح قائد السلاجقة زعيماً للجهاد، وحريصاً على نصرة الاسلام ونشره في تلك الديار، ورفع راية الاسلام خفاقة على مناطق كثيرة من أراضي الدولة البيزنطية
لقد بقي سبع سنوات يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف، قبل أن يقوم باي توسع خارجي.
وعندما أطمئن على استتباب الأمن، وتمكن حكم السلاجقة في جميع الأقاليم والبلدان الخاضعة له، أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة، وهي فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته، وإسقاط الخلافة الفاطمية العبيدية في مصر، وتوحيد العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنيّة ونفوذ السلاجقة، فأعد جيشاً كبيراً أتجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا، فافتتحها وضمها إلى مملكته، كما عمل على نشر الاسلام في تلك المناطق. وأغار ألب أرسلان على شمال الشام وحاصر الدولة المرداسية في حلب، والتي أسسها صالح بن مرداس على المذهب الشيعي سنة 414هـ/1023م وأجبر أميرها محمود بن صالح بن مرداس على إقامة الدعوة للخليفة العباسي بدلاً من الخليفة الفاطمي/ العبيدي سنة 462هـ/1070م. ثم أرسل قائده الترك أتنسز بن أوق الخوارزمي في حملة الى جنوب الشام فأنتزع الرملة وبيت المقدس من يد الفاطميين العبيديين ولم يستطيع الاستيلاء على عسقلان التي تعتبر بوابة الدخول الى مصر، وبذلك أضحى السلاجقة على مقربة من قاعدة الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي داخل بيت المقدس.
Click here to enlarge
حملة ملاذكرد
لقد أغضبت فتوحات ألب أرسلان دومانوس ديوجينس امبراطور الروم، فصمم على القيام بحركة مضادة للدفاع عن امبراطوريته. ودخلت قواته في مناوشات ومعارك عديدة مع قوات السلاجقة، وكان أهمها معركة ملاذكرد في عام 463هـ الموافق أغسطس عام 1070م.قال ابن كثير: وفيها أقبل ملك الروم ارمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والرخ والفرنج، وعدد عظيم وعُدد ، ومعه خمسة وثلاثون ألفاً من البطارقة، ومعه مائتا ألف فارس، ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاً، ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفاً ، ومعه مائة ألف نقّاب وخفار، وألف روزجاري، ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير، وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والمناجيق، منها منجنيق عدة ألف ومائتا رجل، ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الإسلام وأهله، وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد، واستوصى نائبها بالخليفة خيراً، فقال له : ارفق بذلك الشيخ فانه صاحبنا، ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة، فاستعادوه من أيدي المسلمين ، والقدر يقول : {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} سورة الحجر: الآية : 72.
Click here to enlarge
هذه المنمنمة الفرنسية من القرن الخامس عشر تصور معركة ملاذ كرد, المحاربين متدرعين بزي الحرب الاوروبي الغربي المستخدم آنئذ.
أسرع ألب أرسلان بقواته الصغيرة، واصطدم بمقدمة الجيش الرومي الهائل، ونجح في تحقيق نصر خاطف، يحقق له التفاوض العادل مع القيصر؛ لأنه كان يدرك أن قواته الصغيرة لا قِبَل لها بمواجهة هذا الجيش العظيم، غير أن القيصر رفض دعوة ألب أرسلان إلى الصلح والهدنة، وأساء استقبال مبعوثه؛ فأيقن ألب أرسلان ألاَّ مفرَّ له من القتال، بعد أن فشلت الجهود السلمية في دفع الحرب؛ فعمد إلى جنوده يشعل في نفوسهم رُوح الجهاد، وحب الاستشهاد، والصبر عند اللقاء، ووقف الإمام "أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري" يشد من أزر السلطان، ويقول له: "إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح".
وحين دنت ساعة اللقاء صلَّى بهم الإمام أبو نصر البخاري، وبكى السلطان؛ فبكى الناس لبكائه، ودعا، ودعوا معه، ولبس البياض وتحنَّط وقال: "إن قُتِلت فهذا كفني".
والتقى الفريقان بمكان يقال له الزهوة، في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند الروم، فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين ، فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفئتان، نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل، ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره، فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً، وأسر ملكهم ارمانوس، أسره غلام رومي، فلما أوقف بين يدي الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاثة مقارع وقال : لو كُنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ قال : كل قبيح، قال فما ظنك بي؟ فقال: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني. قال : ما عزمت على غير العفو والفداء. فأفتدى منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار. فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه، وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالاً وإكراماً، وأطلق له الملك عشرة ألف دينار ليتجهز بها، وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخاً، وأرسل معه جيشاً يحفظونه إلى بلاده، ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله،....
Click here to enlarge
عندما اُحضـِر الامبراطور رومانوس الرابع إلى ألپ أرسلان, لم يصدق أرسلان أن الرجل الجريح ذو الملابس الممزقة المغطى بالوحل هو امبراطور الروم القوي وبعد تأكده من أن الأسير هو الامبراطور, نقلت عدة مصادر الحوار الشهير التالي الذي دار بينهما:
ألپ أرسلان: "ماذا كنت ستفعل لو أحضروني أسيراً إليك؟" رومانوس: "ربما كنت سأقتلك, أو أعرضك في شوارع القسطنطينية." ألپ أرسلان: "عقوبتي ستكون أشد قسوة. سأعفو عنك, وأطلق سراحك." وبعد أن وضع السلطان السلجوقي حذاءه على رقبة الإمبراطور وأجبره على تقبيل الأرض, عامله برفق ملحوظ وأعاد عرض شروط السلام نفسها التي عرضها عليه قبل المعركة.
ظل رومانوس أسيراً لدى السلطان لمدة أسبوع. خلاله, كان يتناول الطعام على مائدة السلطان بينما كان التفاوض يجري حول تنازل البيزنطيين عن أنطاكية, إدسـّا, هيراپوليس و ملاذ كرد. ولم تمس التنازلات قلب الأناضول الهام للبيزنطيين. طلب ألپ أرسلان فدية قدرها 10 مليون قطعة ذهب للإفراج عن الامبراطور، الذي اعتراض على فداحة المبلغ. فخفض السلطان المبلغ إلى فدية فورية قدرها 1.5 مليون قطعة ذهب يتبعها مبلغ سنوي قدره 360,000 قطعة ذهبية. وأخيراً, سيزوج رومانوس احدى بناته للسلطان. وبعد ذلك أعطى السلطان الامبراطور العديد من الهدايا وسمح له بالعودة برفقة أميرين ومئة مملوك إلى القسطنطينية.
وبـُعيد عودته إلى رعيته, وجد رومانوس حكمه في أزمة خطيرة. وبالرغم من محاولاته لحشد قوات موالية له, فقد هـُزِم ثلاث مرات في معارك ضد أسرة دوكاس وخـُلِع عن العرش, وثـُمِلت عيناه ونـُفـِي إلى جزيرة پروتي; وبعد ذلك بفترة وجيزة, توفي نتيجة الإصابة أثناء العملية الوحشية لثمل عينيه. وآخر مرة شاهد فيها رومانوس قلب الأناضول الذي أمضى حياته مدافعاً عنه كانت مهينة له إذ وُضـِع على حمار مشوه الوجه لإهانته.
لقد كان نصر ألب أرسلان بجيشه الذي لم يتجاوز خمسة عشر ألف محارب على جيش الإمبراطور دومانوس الذي بلغ مائتي ألف، حدثاً كبيراً، ونقطة تحول في التاريخ الاسلامي لأنها سهلت على اضعاف نفوذ الروم في معظم أقاليم آسيا الصغرى، وهي المناطق المهمة التي كانت من ركائز وأعمدة الإمبراطورية البيزنطية. وهذا ساعد تدريجياً للقضاء على الدولة البيزنطية على يد العثمانيين.
لقد كان ألب أرسلان رجلاً صالحاً أخذ بأسباب النصر المعنوية والمادية، فكان يقرب العلماء ويأخذ بنصحهم وما أروع نصيحة العالم الرباني أبي نصر محمد بن عبدالملك البخاري الحنفي، في معركة ملاذكرد عندما قال للسلطان ألب أرسلان: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره و إظهاره على سائر الأديان. وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين.
Click here to enlarge
لم يتحرك الأتراك إلى الأناضول حتى وفاة ألپ أرسلان في 1072. إلا أن الإمبراطورية البيزنطية كانت ما زالت في حرب أهلية فوضوية ولم تقم بأي مقاومة فعالة.
المعركة كانت أوج الفتح التركي للأناضول وقد تبعها بعد عامين سيل عرم من المستوطنين والجنود الأتراك, كثير منهم بطلب من الامبراطورية البيزنطية المتداعية. إلا أن المعركة لم تكن المذبحة التي صورها العديد من المؤرخين, بما فيهم الكتاب الذين عاصروها, — فأعداد ضخمة من المرتزقة وجنود السخرة الأناضوليون فروا من الجيش البيزنطي ونجوا من المعركة, والفضل الجزئي في ذلك يعود لقرار ألپ أرسلان بألا يطاردهم. وبالرغم من النصر الساحق للسلاجقة فإن معظم قادة الجيش البيزنطي بقوا أحياءً بما فيهم رومانوس . وقد شاركوا في قمع القلاقل الداخلية التي اجتاحت الأناضول بعد المعركة. إلا أن الامبراطورية البيزنطية لن تستطيع حشد مثل هذا الجيش الجرار بعد ذلك, ولن تستطيع فرض سلطانها كما كانت قبل تلك المعركة.
افتدى الروم قيصرهم بفدية كبيرة قدرها مليون ونصف المليون من الدينارات، وعقدوا صلحًا مع السلاجقة مدته خمسون عامًا، وتعهدوا بدفع جزية سنوية طوال هذه المدة، واعترفوا بسيطرة السلاجقة على المناطق التي فتحوها من بلاد الروم، وتعهدوا بعدم الاعتداء على ممتلكات دولة السلاجقة.
وكان من نتائج هذا النصر العظيم أن تغيرت صورة الحياة والحضارة في هذه المنطقة؛ فاصطبغت بالصبغة الإسلامية بعد أن أشرقت عليها شمس الإسلام، ودخل سكانها في الإسلام، وتعلموا مبادئه وشرائعه.
Click here to enlarge
دولة السلاجقة في القرن5 هجري
=========
>>>> الرد الثالث :
شكرا اخي و لكن احنا قرينا هذه الدروس
=========
>>>> الرد الرابع :
بسم المحبة مادامت المحبة من الأمل بسم الأمل مادام الأمل من القدر
قصه قصيرة مرة واحد رايح السوق يتسوق للسفر... لأن الصيف جاي و الناس كلها خارج البلد... مافيه أحد قاعد بالديرة... المهم... و هو ماشي... لقى مكتوب على جدار محل من المحلات... و بخط كبير و عريض... .: الله لا إلَه إلا هُو الحَيُّ القَيّومُ :. استغفر الله العظيم واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لاالـه الا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير سبحان الله . والحمد الله . ولا اله الا الله . والله اكــــــــــــــبر وهو يقرأها مر بجانبه شخص... فقال له... هل تدري... أنت حصلت على 240 حسنة ؟؟؟ و إلي كاتبها على الجدار حصل على 240 حسنة ؟؟؟ و حتى كاتب هذه القصة حصل على 240 حسنة ؟؟؟ وحتى أنا أخذت 240 حسنة... لأني نشرتها... و أي أحد بيقرأها... بيزيد أجري... أقسم بالله... الإسلام دين يسر...
=========
>>>> الرد الخامس :

=========
شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ككككككككرررررررررررررررررررررررررررررااااااااااااا اااااا
لا شكر على واجب
بالتوفيق للجميع
المستوى : الثـالث متوسـط الزمـن : ســاعتـــان
الفرض الثلاثي الأول في مادة التاريخ و الجغرافيا
أولا: التاريخ .( 13 نقطة)
الجزء الأول : (09ن)
الوضعية الأولى:
عاش العالم الإسلامي أواخر العهد العباسي تحولات هامة أدت إلى حدوث اضطرابات و بالتالي سقوط الدولة العباسية
01 - حدد الإطار الزمني للخلافة العباسية .
02 - أذكر- ثلاث- دويلات حكمت باسم الخلافة العباسية .
03 - ما اسم الدولة التي جمعت شمل العالم الإسلامي بعد العباسيين ؟
الوضعية الثانية:
اربط بسهم بين الحدث وما يناسبه من زمن تاريخي:
- تأسيس الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط . - 1236م
- انهزام المسلمين في معركة حصن العقاب بالأندلس . - 1492م
- سـقوط غرناطة أخر معاقل المسلمين في الأندلس . - 1212م
- انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين . – 1187م
الجزء الثاني : (04ن)
السياق : عرضت قناة الجزيرة الوثائقية شريطا تاريخيا حول علاقة المسيحيين بالمسلمين في الأندلس
و بلاد المغرب . فسألك والدك عن أسباب طرد المسلمين من قبل الصليبيين و نتائج ذلك .
السند1: " تصدعت قوى الموحدين بعد وفاة الخليفة محمد الناصر ، فكثر النزاع على السلطة و الملك و بقيت الأندلس دون غطاء عسكري، فانفتح الباب على مصراعيه لتحرشات ممالك اسبانيا المسيحية...." من الكتاب المدرسي
السند2: " ..... ثم إن ديوان التفتيش أجبر من بقي من المسلمين في إسبانيا على اعتناق النصرانية ، غير عابئ بما
نصت عليه شروط تسليم غرناطة ......." كارل برو كلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية
التعليمة : اعتمادا على ما جاء في السندات السالفة الذكر و مكتسباتك الشخصية . أجب عن تساؤل والدك
ثانيا : الجغرافيا :07 نقاط)
الجزء الأول: (04ن)
* تتميز قارة أوقيانوسيا عن بقية القارات في طبيعة تشكلها و تعميرها .
01- بم تتميز هذه القارة عن غيرها من القارات جغرافيا ؟
02- كيف تم تعمير قارة أوقيانوسيا ؟
03- ما أهمية كل من أستراليا و نيوزيلندا في القارة ؟
الجزء الثاني: (03ن)
* شهدت أوربا بسبب الثورة الصناعية تحولات كثيرة في جميع الميادين .
01– عرف الثورة الصناعية .
02- ما أثر ذلك على أوروبا و العالم ؟
بالتوفيق إن شاء الله
يا ملاك راني لقيتك
تعرفي التاريخ وديري روحك تعرفي غي الرياضيات و العلوم
نهار الاحد نتفاهم معاك
slm serine 7ata ana rani l9itek et bin nhare l7ade nchalah
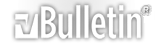


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس