عنوان الموضوع : تكوين المعلم ....هام من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
تكوين المعلم بين حاجات الحاضر وتوقعات المستقبل ناصر محمد الشيخ
يشير جاك حلاق في كتابه "الاستثمار في المستقبل" الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط سنة 1990م إلى أن هناك دور حيوي للتعليم في تنمية الموارد البشرية وفي تقدم الأفراد والمجتمعات، وبالتالي على الأولوية التي يجب أن تعطيها الحكومات للتعليم وتنمية الموارد البشرية عند تخصيص الموارد القومية، كما أن الحاجة إلى الترابط الوثيق والمتزامن بين تنمية الموارد البشرية وسياسات التنمية الشاملة.
وهناك أربعة مجالات رئيسة سوف تؤثر في الاتجاهات المستقبلية للتعليم وتنمية الموارد البشرية ولا ينبغي لصانعي السياسات إغفالها وهي التحول المتزايد نحو التحضر، والمتطلبات الثقافية، والسيادة المتنامية للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الجامعات، واحتمالات المستقبل الاقتصادي التي يصعب التنبؤ بها.
وعلى صانعي السياسات عند رسم خارطة لأولويات الاستثمار في التعليم والتكوين أن يدخلوا في اعتبارهم الحاجة إلى :
.1 تصحيح الاختلالات.
.2 الوصول إلى هدف محو الأمية للجميع.
.3 الإقلال من الفوارق في إمكانية الالتحاق بالتعليم.
.4 التوسع في الاستيعاب.
.5 تحسين النوعية.
.6 زيادة الكفاءة في استخدام الموارد.
ولا يمكن أن تكون نفس الأولويات صالحة لجميع البلاد، كما أنها لا يمكن أن تنفذ على الفور وكلها في نفس الوقت، لذا من الضروري أن يتعرض لها كل بلد في ضوء قضاياه العملية وقدراته وأن يميز ويتخير لنفسه برنامجاً للعمل خاصاً به.
ويدخل ضمن بند تحسين النوعية وزيادة الكفاءة موضوع المعلمين، فالاستثمار في المعلمين وتدريبهم ومعاونتهم وظروف اختيارهم وأوضاعهم أمر حيوي للغاية كما أن دورهم في تنفيذ السياسة التعليمية من الخطورة بمكان بحيث لا تستطيع حكومة أن تنظر في تحسين الجودة والكفاءة نظرة جدية دون إعطاء موضوع المعلمين أولوية عالية.
وكون مرتبات المعلمين هي أكبر البنود بين التكاليف المتكررة في التعليم لا يعطيها ضماناً بأن أولوياتهم عالية وكافية في التوزيع العام للموارد حيث إن إمكانية التوسع وتحسين النوعية متوقفة بدرجة كبيرة على اجتذاب قوة تدريسية مستقرة وجيدة الإعداد وقوية الدافعية ومسؤولة. فإذا تعذر ذلك فعلى الجهات المعنية بالقرار التربوي اقتراح اتجاهات أخرى لتحقيق أهداف الجودة والتحسين وقد يقود التفكير إلى مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في زيادة الاستيعاب المدرسي وتحسين نوعية نتائج التعليم.
التعليم والمعلمون مكان الصدارة في عقد التسعينات
يشير تقرير اليونسكو عن التربية في العالم المنشور عام 1991 إلى أنه من المرجح أن يحتل التعليم والمعلمون مكان الصدارة في النقاش الذي يدور حالياً حول السياسة التعليمية أثناء عقد التسعينات. >فالحجج التي تساق في تأكيد أهمية الموارد البشرية في سائر قطاعات الاقتصاد والمجتمع تنطبق بنفس القوة في قطاع التعليم ذاته. ولا يتوقع أن يطرأ تحسن على نوعية التعليم عموماً أو على نتائج التعلم بوجه خاص دون تعاون صادق ومعاونة من جانب معلمين أكفاء والمسألة ليست مجرد نوعية المعلمين بالمعنى الشكلي المتمثل في التدريب أو الحصول على دبلوم وإنما هي أيضاً مسألة دافع والتزام.
الاحتياجات من المعلمين وحشدهم
يشير نفس التقرير السابق إلى قرابة 44 مليون من المعلمين يعملون في الوقت الحاضر في مؤسسات التعليم النظامي في العالم وهم يمثلون زهاء 1 % من مجموع سكان العالم. وإذا ما أضفنا الأشخاص الذين يعملون في التعليم خارج مؤسسات التعليم النظامي فإن أعداد المعلمين أكبر بكثير من ذلك العدد.
ومن منظور عالمي يتوقع أن يزيد عدد المعلمين في كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية نظراً لتوقع نمو في أعداد التلاميذ المسجلين. وسوف تشكل هذه الأعداد المتزايدة تحديداً هائلاً بالنسبة إلى حشد وتدريب المعلمين. وإذا أريد تحقيق إسقاطات اليونسكو حول نمو التعليم حتى عام 2017م فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً لن يتسنى تحقيقها دون زيادات كبيرة في نصيب التعليم من الموارد الوطنية. وعلى الرغم من ذلك فإن السيناريو المطروح ينطوي على قدر من التخمين ومن الممكن أن تتباين كثيراً تجارب الدول فيما بينها وتبقى المشكلة الكبرى العائقة لحشد المعلمين وتدريبهم واستبقائهم في الخدمة هي عدم وجود معلومات منتظمة عن معدل الاستبدال في القوى العاملة بالتعليم وتجديدها. والاتجاه العام السائد هو أن هذا المعدل يزيد في الدول المتقدمة وينخفض في الدول النامية.
الاتجاهات العالمية لإعداد المعلمين وتدريبهم
عند محاولة معرفة الاتجاهات الإقليمية والعالمية في إعداد المعلمين وتدريبهم فإن هناك صعوبة واضحة لحصر اتجاهات واضحة على الرغم من أن شريحة عريضة من الدول تتجه نحو رفع المستوى التعليمي للقوى العاملة بالتعليم، إلا أن المستوى السائد لهذه القوى يتراوح بين مستوى الثانوية العامة والمستوى الجامعي الأول.
ويبين تقرير اليونسكو حول التربية المنشور عام 1991م أنه لا يبدو أن المعلمين ذوي المؤهلات المرتفعة أقدر من زملائهم الأقل تعليماً في بلدان أخرى على الأخذ بيد تلاميذهم ومساعدتهم على تخطي عقبة المعرفة الآخذة في الارتفاع (5).
وهناك صعوبات أخرى تحد من معرفة الاتجاهات العالمية في إعداد المعلمين وتدريبهم ألا وهي صعوبة توثيق التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على توسيع وتنويع تدريب المعلمين أثناء الخدمة، بل وقد تكون الأسباب أكثر تحديداً إذا كانت هذه التغيرات هي تغيرات في إدراكنا لطبيعة التعليم والمهارات المطلوبة للقيام به على نحو فعال. وبمعنى أوضح عندما ندرك أن برامج الإعداد والتكوين قبل الخدمة لا تستطيع أن تكفل مستوى فعال من الأداء في التعليم فمن المرجح أن يكون الاعتقاد هو تنمية مهارات المعلمين أثناء الخدمة ولا يمكن أن تتحقق هذه التنمية إلا بفعل الخبرة العملية المكتسبة التي لابد أن تحظى منا بمزيد من الاهتمام (5).
ولا تتوفر معلومات عالمية منتظمة عن نسب القوى العاملة في مختلف مستويات التعليم ولكن يبدو أن أعداد المعلمين الذين لم يتلقوا أي إعداد قبل الخدمة كبير في أجزاء كثيرة من العالم وذلك ناتج عن الضغوط الاجتماعية لزيادة الطلب على التعليم (5).
كما أن الالتزام بالتعليم من قبل المعلمين أمر لا يمكن التأكد منه وإذا ما كان هذا الالتزام شرطاً مسبقاً لممارسة التعليم فإن مشاعر الضيق تسيطر على عامة القوى العاملة في التعليم. ومن جهة أخرى لا يمكن تبديد الشكوك حول نوعية التعليم المقدم في المدارس بمجرد ابتكار وتنفيذ برامج التعليم قبل وأثناء الخدمة. وتصل شكوك الباحثين في أوروبا وأمريكا الشمالية في نوعية التعليم إلى درجة التساؤل عن مدى تأثير المعلمين على تعلم التلاميذ وكيف يمكن أن يتحسن التعلم إذا غاب المعلمون (5).
ويبين جاك حلاق في كتابه "الاستثمار في المستقبل" (2) أن الطريقة الأفضل لقياس جودة المدرسة هي بتقدير مؤشرات الناتج أي ما تعلمه الطالب بالفعل فالمدرسة التي تنتج قدراً أكبر من التعلم لدى الطلاب بنفس القدر من المدخلات قد تكون هي المدرسة الأفضل. كما أن المؤشرات التقليدية مثل متوسط الإنفاق السنوي على التلميذ لا تجدي في هذا المجال وهي إفرازات قصور البيانات مما اضطر الباحثين للتساهل في أساليب قياس الجودة.
وإذا كان الهدف فعلاً رفع الكفاءة الخارجية للتعليم باستخدام أسلوب التحفيز فإن الأمر غاية في التعقيد نظراً لنوع العلاقة بين منتجي ومستهلكي التعليم. وهنا لابد من تصميم الحوافز وتطبيقها بحكمة وفي مواقف محددة لتوجيه أنشطة المدرسين والطلبة نحو الإنجازات التعليمية التي تهم المجتمع.
وقد تفشل بعض المشاريع المتعلقة بالحوافز في التحكم في سلوك المدرسين وتغير الناتج التعليمي فالمدارس كائنات حية معقدة لا يمكن دائماً قياس أنشطتها اقتصادياً. أضف إلى ذلك أن هناك خواص لصيقة بمهنة التعليم تحول دون فعل واضح للحوافز وعلى زيادة إتقان المعلمين لعملهم فعلى سبيل المثال يعتبر التعليم عملاً انعزالياً بصورة عامة باستثناء بعض الممارسات التي تقوم على عمل الفريق الواحد. كما أن المدرسين لا يرون بعضهم بعضاً وهم يعملون ومتى أغلق الباب على المدرس وانفرد في غرفة الصف مع 30 أو 40 طالباً فإنه يكون بمثابة المركز لمن يعلمهم تماماً كأي مدرس آخر في النظام ؛ وخواص طريقته غير ملموسة ومن الصعب تقييمها والمعايير المتاحة هي فقط أكثر جوانب العمل عرضة للملاحظة مثل عدد ساعات العمل في الصف، وطريقة معالجة مشاكل النظام والانتظام وحضور الاجتماعات وعدد الانتقادات التي يوجهها التلاميذ والآباء للمعلم.
وكل هذه المؤشرات السابقة الذكر مشوشة ولا يمكن الاعتماد عليها نهائياً لتقرير الكفاءة والإنتاجية للمدرسين وهنا تكون السذاجة إذا تم مكافأة المعلم البارز وفقاً للمؤشرات السابقة بواسطة الحوافز. وقد يكون من المجدي في شأن الحوافز أن تستخدم بشكل جماعي ولمجموعة من المعلمين أو المدرسة كمؤسسة تعليمية في المجتمع وإن لم تكن هناك دراسات أو شواهد تثبت جدوى ذلك.
كيف يكون الارتقاء بفعالية المعلمين ؟
يشير لورين أندرسون في كتابه الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي سنة 1992م الذي ترجمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1994م، أنه لاشيء يدل على أن الحوافز المقدمة للمعلمين خاصة الزيادة في أجورهم أو الضغوطات التي تفرض عليهم والتي تجبرهم مثلاً على الامتثال للتعليمات الرسمية تؤدي دائماً إلى تطور ملاحظ ومستديم لفعالية تعليمهم. وعليه لابد أن تتخذ الخطوات المبدئية التالية لزيادة الفعالية :
.1 تخطي التردد تجاه التغيير : عن طريق اقتناع المعلمين ووعيهم بضرورة التغيير، وتزويدهم بالمعارف من خلال برامج التدريب أثناء الخدمة فضلاً عن تغير اعتقادهم بأن التغيرات لا يتأتى منها شيء.
.2 تقديم الإعانة للمعلمين المقبلين على تطوير أدائهم من خلال شتى الوسائل داخل مدارسهم مثل إعطاء المعلمين فرصة للاعتبار بالأخطاء المرتكبة والانتفاع من تجربة الآخرين والتعامل معهم باعتبارهم أفراداً بدلاً من مخاطبتهم جميعاً.
التكوين :
هناك ثلاثة مجالات حيوية للسياسة فيما يتصل بالمعلمين في حقل التعليم وهي : المال والتكوين والدعم الإداري والتعليمي. وعلى صانعي السياسات أن يكونوا راغبين في مواجهة هذه المستويات الثلاثة وإلا فإن القيود الحرجة التي تفرضها العوامل المرتبطة بالمعلمين ستحد من تنمية الأنظمة التعليمية في المستقبل. لأن نوعية التعليم تتوقف بالدرجة الأولى على نوعية المعلمين.
ولن نتطرق بالتفصيل إلى موضوع المال فهو شحيح وكل الدول ما عدا الصناعية تعاني من ندرته إلا أن أمر استخدام المال بكفاءة عن طريق رصد الهدر الناتج عن عدم استخدام المعلم بفاعلية وتقليل ساعات عمله دون مبررات هو الاتجاه المتوقع لإعادة تدوير المال وصرفه على الحاجات الملحة.
أ) اتجاهات التكوين : (2)
تبين الدلائل أن الاتجاه العام يميل إلى توحيد برامج تكوين المعلمين لمختلف المستويات التعليمية. كما أن الفروق بين تعليم المعلمين قبل وأثناء الخدمة وبين التعليم المبدئي والمستمر قد أصبحت غير واضحة بعد إدخال برامج العمل / الدراسة والتدريب عن بعد والتنمية المهنية المستديمة داخل المدرسة. فلم يعد يقتصر تكوين المعلمين على برنامج دراسي مدته سنتان أو أكثر قبل الالتحاق بالمهنة بل أصبح التدريب أثناء الخدمة عنصراً هاماً في عملية التمهين كسائر المهن الفنية الأخرى، خاصة في ظل حاجة العديد من الدول إلى تعيين المعلمين غير المؤهلين للمهنة بسبب التعميم السريع للتعليم، كما أن هؤلاء المعلمين يبقون إلى الأبد ويصبحون عقبات كبرى في طريق التحسين النوعي وتتزايد صعوبة تكيفهم مع توقع ارتفاع مستوى تعليم مجتمعاتهم المحلية.
وتدل الشواهد على أن تدريب المعلمين غير المؤهلين أثناء الخدمة لم يكن كافياً للأسباب التالية :
.1 البرامج سيئة الإعداد ومحتوياتها تفتقر إلى التواؤم مع المقررات التي ينتظر من المعلمين تعليمها.
.2 هذه البرامج نظرية بشكل واضح وغير قابلة للتطبيق على حاجات المعلم في عمله اليومي.
.3 أعضاء هيئة التعليم الذين يقدمونها ليسوا على دراية بالتجديدات التعليمية.
.4 جداولها غير منتظمة وتعجز عن تعزيز معرفة المتعلمين أو تحسين مهاراتهم وكفاءتهم بدرجة ملحوظة.
.5 تفرض عبئاً أثقل مما ينبغي على المعلمين المثقلين بالعمل والذين تثبط هممهم عن الانتظام في هذه البرامج.
.6 لا يفيد إلا قلة قليلة من المعلمين ولا تبلغ ما تحت القمة الظاهرة لجبل الثلج الذي يمثله المعلمون غير المؤهلين بالمهنة.
.7 لا تؤثر مادياً في الأداء لأن الظروف السيئة التي يعمل فيها المعلمون في الفصول الدراسية ـ من إمكانات غير كافية ونقص في المواد التعليمية وعدم وجود دعم تعليمي ـ ما زالت قائمة.
وفي دراسة أجراها مايكل هارتلي وأرك سوانسن عام 1984م (9) حول أثر عدد من العوامل من بينها مواصفات المعلمين والبرنامج المدرسي على التحصيل العلمي في مادتي القراءة والحساب تبين أن لمستوى الشهادة التي يحملها المعلم علاقة إيجابية في التحصيل في مادة القراءة ولكن لم يظهر لها تأثير في مادة الحساب كما لم يظهر تأثير لعدد سنوات الخبرة في التعليم التي يمتلكها المعلم بخلاف الحصول على التدريب أثناء الخدمة الذي كان له بعض التأثير. ويذكر منير بشور الذي أورد هذه الدراسة في المقالة الواردة في نتائج ورشة العمل حول التخطيط لتحسين نوعية التعليم الأساسي في إطار التعليم للجميع في الدول العربية الذي نشرته اليونسكو عام 1995م أنه من الضروري أن لا تقل الدرجة العلمية للمعلمين عن الشهادة الجامعية الأولى وأن تتوفر لهم دورات تدريبية بمعدل واحدة كل ست سنوات.
ويذكر الدكتور عبد الله عبد الدائم في استقصاء حول التجارب العالمية لإعداد المـعلمين (6) أن إعـداد المـعلمين قبـل الخـدمة يتـم في بعـض الـدول على المـستوى الجامعي، أما سائر الدول فما يزال معظمها ينزع إلى إعداد المعلمين عن طريق معاهد خاصة للمعلمين بعد المرحلة الثانوية ومدة الدراسة والتدريب فيها يتراوح بين عامين وأربعة أعوام. ويضيف أن تدريب المعلمين أثناء الخدمة يأخذ أشكالاً مختلفة باختلاف البلدان بل المناطق في البلد الواحد وهناك إجماع على النقاط التالية في كافة البرامج التدريبية أثناء الخدمة :
ـ التدريب المستمر مدى الحياة.
ـ التكامل بين الإعداد قبل الخدمة والتدريب أثناءها.
ـ ازدياد الاهتمام بالتدريب أثناء الخدمة.
ـ يستند وضع برامج التدريب أثناء الخدمة على نتائج البحث التربوي وحاجات النظام التربوي.
ـ من أهم عناصر بناء برامج التدريب تقويم عمل المعلمين وتقويم إنجاز الطلبة.
ـ يعنى التدريب أثناء الخدمة بتكوين القدرة على التعلم الذاتي.
ب) احتمالات المستقبل :
.1 الاتجاه نحو الإعداد بالمستوى الجامعي :
يؤكد جاك حلاق في كتابه الاستثمار في المستقبل (2) ما جاء في تقرير اليونسكو عن التعليم لسنة 1991م أنه يتوقع تزايد الإقبال على التعليم، وينتج عن ذلك طلباً متزايداً على أعداد من المعلمين الجدد. وسوف تكون الهياكل القائمة والمعاهد العليا على إعداد معلمين أكثر من كافية لمواجهة هذا الطلب في بعض البلدان ولكن أكثرها ستحتاج إلى التوسع وإلى إلغاء أو إعادة توزيع المعاهد غير الفعالة. وربما يكون الإعداد الجامعي أفضل لأن الطلاب عادة يدفعون تكاليف فرص دراستهم.
.2 التأكيد على المتطلبات الأكاديمية والمتطلبات المهنية دون خلط :
وهنا لابد من تحديد ماذا يدرس هؤلاء المعلمين الجدد ؟ وأين تتم الدراسة ؟ وما هي مدتها ؟ ويجيب جاك حلاق على هذه التساؤلات فيذكر أن هناك إجماعاً واسعاً على أن معلمي التعليم الابتدائي يجب أن يتقنوا المعلومات والمهارات المتعارف عليها والمتوقعة منهم في مجتمعاتهم. وأن تكون لديهم القدرة على التعليم تحت ظروف متباينة. ويجب عدم الخلط بين المتطلبات الأكاديمية والمتطلبات المهنية. فمتى تم اكتساب التعليم الأكاديمي الذي يعد ضرورياً يجب التركيز على التدريب المهني. فالتدريب المهني ضروري للمعلمين على كافة المستويات وفي جميع أساليب وأدوات التعليم.
ولكي تكون برامج التدريب أثناء الخدمة فعالة يجب تصميمها بحيث تتمشى مع مستوى التكوين الذي حصل عليه المعلم قبل الخدمة مع ملاحظة حاجة المعلمين الدائمة إلى تعليم مستمر أثناء الخدمة لكي يبقوا على اتصال بكل جديد ومتغير في مهنتهم ويحسنوا أداءهم.
.3 الاتجاه نحو التمهين :
ويبين الدكتور أحمد صيداوي (7) في ورقته لندوة : نحو استراتيجية مقترحة لتمهين التعليم في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج والمنشورة عام 1996م، أنه من أبرز الإصلاحات التربوية التي نجمت عن تقريري موسسة كارنيجي ومجموعة هولمز الأمريكيتين اقتراح ينحو إلى تعزيز ثقافة المعلمين المهنية بحيث يحصل الطالب المعلم على الدرجة الجامعية الأولى في مادة من مواد التعليم ثم يحضر للدراسة العليا في التربية ويتتلمذ في مدرسة النمو المهني على غرار المستشفى التعليمي.
.4 الاتجاه نحو تكوين آليات وإجراءات محددة عند الإعداد :
وقد أكدت لجنة إعداد المعلمين في دولة البحرين في تقريرها الصادر عام 1989م (8) على عدد من التوصيات في هذا المجال ولعل أهمها :
ـ وجود فلسفة للإعداد انطلاقاً من أن كل عمل تربوي اجتماعي يفترض أن يكون مسبوقاً بفلسفة مجتمعية أخلاقية واضحة ومحددة تجاه المتعلم والوطن والمستقبل.
ـ النظر بصورة متكررة في مناهج إعداد المعلمين لأسباب كثيرة وعديدة.
ـ مشاركة وزارة التربية والتعليم مع الجامعات ومعاهد الإعداد على أساس تلمس الحاجات والمتابعة المستمرة.
ـ الميل إلى مد فترة الإعداد.
ـ تنفيذ سياسة واضحة لقبول الطلبة في كليات ومعاهد الإعداد ولقبول المعلمين المتخرجين في مهنة التعليم تعتمد أساساً على إجراء الاختبارات التحريرية المقالية.
ـ التأكيد على أهمية الإعداد المستمر بعد التخرج وأثناء الممارسة والتعلم الذاتي للمعلمين.
.5 الاتجاه نحو تعزيز دور المعلم في نظم التقييم :
ويتوقع أن يكون لدور المعلم (5) في نظم تقييم تحصيل التلاميذ شأن كبير في النصف الثاني من هذا العقد، وأن تكون هذه المسألة حاسمة بالنسبة لوضع المعلم داخل النظام التعليمي وبالنسبة لمصداقية عملية تقييم نتائج التعلم. فالعديد من الدول بدأت تدخل برامج تقييم وطنية يعرفها الجمهور، كما أثيرت على الصعيد الدولي إمكانية تحديد مستويات يمكن قبولها عند التعرض لاكتساب المعرفة، وكذلك كيفية تحسين وتطبيق نظم الإنجاز التعليمي. ويتوقع أن يكون دور المعلم بالغ الأهمية في هذه القضايا وهناك ثلاثة اتجاهات عالمية في ممارسة التقييم :
ـ التعليم من أجل الاختبار.
ـ التقييم المنطلق من المدرسة.
ـ التقييم التشخيصي التكويني.
.6 الاتجاه نحو تغيير دور المعلم نتيجة للتطور التكنولوجي :
يذكر مشروع استراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل لسنة 2017-96م (4) أنه لابد من إعادة النظر في دور المعلم في المرحلة القادمة آخذين بعين الاعتبار التغير السريع في بيئة التعليم التي لن تلبث أن تصبح بلا جدران ولا حدود. فها هي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والطرق السريعة للمعلومات تحطم احتكار المعرفة الذي ظل طويلاً في قبضة النظم التعليمية.
ويبدو أن الدور الجديد للمعلم أخذ يتبلور في كونه الميسر للتعلم الذاتي والمرشد إلى عالم المعلومات بدلاً من المصدر الذي لا يرقى إليه الشك أو المصدر الأوحد للمعلومات.
وأصبح لزاماً عليه أن يتعلم كل ما يتعلق بأدوات وتكنولوجيا التعلم والتعليم بما فـي ذلك مـن إلمـام جـيد باسـتعمال الحـاسوب كأداة تعـليم وتـعلم. ومـجالات اســتخدام الحاسوب (3) في التعليم عديدة ومتنوعة ولا حصر لها ويمكن أن نذكر منها استخدامه للشرح بالطريقة التلقينية والتدريب والممارسة والتطبيقات والاكتشاف وحل المشكلات والمحاكاة.
ولابد هنا من ملاحظة أن الحاسوب لن يستبدل المعلم وإنما المعلم عنصر أساسي وهام في إنجاح استخدامات الحاسوب في التعليم.
مصادر البحث
.1 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، سلسلة مبادئ التخطيط التربوي رقم 39، إنماء فعالية المدرسين، تونس، 1994م.
.2 حلاق، جاك، الاستثمار في المستقبل، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية (يوندباس)، عمان، الأردن، 1992م.
.3 دولة البحرين، وزارة التربية والتعليم، المؤتمر التربوي العاشر (استخدام الحاسوب في التعليم)، استخدام الحاسوب في تيسير التعليم، البحرين، إبريل 1995م.
.4 اليونسكو، مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل (2017-1996م)، 1995م.
.5 اليونسكو، تقرير عن التربية في العالم، 1991م.
.6 عبد الدائم، عبد الله، تجارب عالمية في رفع مستوى المعلمين أثناء الخدمة لدرجة البكالوريوس.
.7 صيداوي، أحمد، خطة مستقبلية لتوسيع خطى التعليم عن طريق التمهين، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ندوة استراتيجية مقترحة لتمهين التعليم في الدول الأعضاء، مايو 1996م.
.8 دولة البحرين، وزارة التربية والتعليم، تقرير لجنة إعداد المعلمين، فبراير 1989م.
.9 مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، التخطيط لتحسين نوعية التعليم الأساسي في إطار التعليم للجميع في الدول العربية، ورشة عمل شبه إقليمية، جمهورية مصر العربية، فبراير 1993م.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
بارك الله فيك على الموضوع المفيد فعلا احداث التغيير ضروري مع مراعاة خصوصية المرحلة والمجتمع بتكوين يتماشى مع التطورات الحاصلة في شتى الميادين وارى ان نعود الى المعاهد المتخصصة كما في السابق
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========
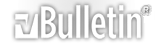


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس